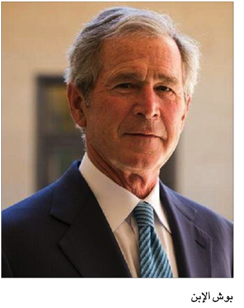«فورين بوليسي»: أسرار فشل السياسة الخارجية الأميركية حتى من قبل ترامب

كتب ستيفن م. والت أستاذ كرسي «روبرت ورينيه بيلفر» للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، مقالاً في مجلة «فورين بوليسي»، أعاد نشره مركز بيلفر، حول السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب، التي انتقدها بشدة بدءاً بالرئيس نفسه الذي يرى أنه لا يسيطر كثيراً على انفعالاته إلى الفرص الضائعة وسوء إدارة العلاقات مع أقرب الحلفاء في أوروبا الذين دأب ترامب على إهانتهم وتهديدهم بسحب أميركا من حلف الناتو.
ويضرب الباحث مثلاً بالسياسة الأميركية تجاه إيران والصين؛ إذ ساعد تخلي ترامب عن الاتفاق النووي إلى إعادة تشغيل طهران لبرنامجها النووي تدريجياً، كما أدّى موقفه من الصين إلى اتساع نفوذها واقترابها من أوروبا أكثر.
ويستهلّ الكاتب مقاله بالإشارة إلى سياسة ترامب في الشرق الأوسط قائلاً: «في آخر عمود كتبته، وصفت سمات «الموت الدماغي» لنهج إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط وخاصة إيران. وعلى وجه الخصوص، أكدت أنّ الإدارة ليس لديها استراتيجية حقيقية، إذا كان المرء يعني بهذا المصطلح مجموعة من الأهداف الواضحة، مقترنة بخطة عمل متماسكة لتحقيقها، وتأخذ في الاعتبار ردود أفعال الآخرين المتوقعة».
ترامب زاد من خطر الحرب
ويتابع الكاتب: «ما لدينا بدلاً عن ذلك هو الإكراه بالقوة الوحشية، البعيدة كلّ البعد عن الأهداف الواضحة، ويتولى تنفيذ هذا النهج «رئيس جاهل» يعاني من ضعف السيطرة على انفعالاته. فبعد ما يقرب من ثلاث سنوات في منصبه تمكن الرئيس دونالد ترامب من زيادة خطر الحرب، ودفع إيران إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي تدريجياً، واستفز العراق لمطالبة الولايات المتحدة بالاستعداد لمغادرة أراضيها، وأثار شكوكاً جدية بشأن الحكمة والموثوقية الأميركية، وأثار فزع الحلفاء في أوروبا، وجعل روسيا والصين تبدوان وكأنهما معينان للحكمة والنظام».
هذه السياسة أوضحت أنّ إدارة ترامب تعتقد أنّ اغتيال مسؤولين أجانب هو أداة شرعية للسياسة الخارجية، وأنه ينبغي الاحتفاء بمجرمي الحرب، وهي خطوة من المرجح أن ترحب بها الحكومات الشريرة وتقلدها.
ويتحسر الكاتب: «لسوء الحظ، فإنّ قصر النظر الإستراتيجي هذا يتجاوز الشرق الأوسط. خذ على سبيل المثال القضية الأكثر أهمية الخاصة بالصين. يرجع الفضل إلى إدارة ترامب في إدراك أنّ الصين هي النظير المنافس الوحيد المرجح أن تواجهه الولايات المتحدة لعقود عديدة. غير أنّ هذا الإدراك ليس مأثرة عظيمة من العبقرية؛ إذ يمكن للأشخاص العقلاء أن يختلفوا حول حجم التحدي الصيني، ولكن الشخص المكفوف فقط هو من يغفل الآثار المقلقة لصعود الصين».
إذا فكرت بطريقة إستراتيجية – يستدرك الكاتب – فستبدأ في البحث عن طرق للحدّ من النفوذ الصيني بأقلّ تكلفة ومخاطر على الولايات المتحدة نفسها. وستفهم أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها إيقاف أو تغيير النمو الاقتصادي الصيني (وبالتأكيد ليس دون الإضرار بنفسها)، لكنك ستعمل بجدّ للحفاظ على أكبر عدد ممكن من البلدان إلى جانب أميركا بشأن القضايا المهمة، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدّمة.
في الواقع ستكون جاداً بشأن محاولة منع الصين من الوصول إلى موقع مهيمن في التقنيات التي يحتمل أن تغيّر المشهد مثل الحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي. وستركز تركيزاً كبيراً على الحفاظ على مكانة دبلوماسية قوية في آسيا، ومع مرور الوقت ستبحث عن طرق لدق إسفين بين الصين وروسيا أيضاً. وستحاول بشدة ألا يتشتّت انتباهك بالقضايا الثانوية وتضييع الوقت، أو الاهتمام، أو رأس المال السياسي، أو الموارد عليها.
إهانة الحلفاء وتهديدهم
كبداية تخلى ترامب عن الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي صفعة في وجه بلدان آسيا والمحيط الهادئ الـ 11 التي عملت بجدّ للتوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يوفر بعض المزايا الاقتصادية المتواضعة ويبقي هذه البلدان أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأميركي، ثم شنّ ترامب حربه التجارية على الصين.
لكن بدلاً من أن يحشد القوى الاقتصادية الرئيسة الأخرى إلى جانبه، هدّدهم وشنّ الحروب التجارية ضدّ معظمهم أيضاً. وبدلاً عن مواجهة الصين بجبهة موحدة، كانت الولايات المتحدة تواجه الصين بمفردها إلى حدّ ما، وهي تعاني من تراجع كبير في النفوذ. والنتيجة المتوقعة: حلّ وسط تجاري ينقذ ماء الوجه ويعيد عقارب الساعة للوراء، ولا يحرز أيّ تقدّم بشأن أوجه الخلاف الحقيقية مع بكين.
بعد ذلك بدأ ترامب نهجه في عرض تلفزيون الواقع تجاه كوريا الشمالية: في البداية يهدّد بـ «النيران والغضب»، ثم ينخدع بوعود كيم يونغ أون الفارغة في اجتماعهما الأول. والنتيجة: عدم إحراز أيّ تقدّم في علاقات الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، وعدم توقف برنامجها النووي، وأيضاً تقلص الثقة في الحكمة الأميركية عبر آسيا.
وفي الوقت نفسه قضى ترامب معظم السنوات الثلاث الماضية في إهانة الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا دون مبرّر وهدّد بسحب بلاده من الناتو. وكانت المفاجأة عندما حاول المسؤولون الأميركيون بعد ذلك إقناع حلفاء أميركا بعدم شراء التكنولوجيا الصينية – وخاصة المعدات الرقمية للجيل الخامس من شركة هواوي – وكان من الطبيعي أن يقابل طلبهم بالتجاهل من الحكومات التي لم تكن في مزاج يسمح لها بمجاملة ترامب.
فيما سارع الدبلوماسيون الصينيون الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة هواوي إلى الاستفادة من أخطاء ترامب المتكرّرة، وأبلغوا المسؤولين الأوروبيين أنهم أكثر التزاماً بتعددية الأطراف والانفتاح التكنولوجي من الولايات المتحدة وسلطوا الضوء على دعمهم لاتفاق باريس للمناخ (وهو اتفاق آخر تخلى عنه ترامب بحماقة)، بحسب الكاتب.
ووفقاً لما تذكره جوليان سميث من صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة: «لقد بدأ الصينيون يدّعون بصفاقة أنّ الصين، وليست الولايات المتحدة، هي التي تشترك في المزيد من القيم مع أوروبا. (إنهم) يُذكرون أيضاّ وبشكل متكرّر الجماهير الأوروبية بأنّ الصين، على عكس الولايات المتحدة، تؤمن بتغيّر المناخ وتعددية الأطراف، وهي رسالة قوية بشكل خاص في مكان مثل ألمانيا».
الدبلوماسية في هذه الحقبة أهم من أيّ وقت مضى
ويتابع الكاتب: «الآنّ ضع في اعتبارك هذا الأمر: في حين تعاني وزارة الخارجية الأميركية من الاضمحلال السريع، تصعّد الصين من تحركاتها؛ إذ يوجد في الصين الآن سفارات وقنصليات ومواقع دبلوماسية أخرى أكثر من الولايات المتحدة، وفي حقبة يعدّ فيها الاصطفاف المستقبلي لعدد من الدول المهمة في متناول اليد».
ووفقاً لنائب وزير الخارجية الأميركي السابق وليام بيرنز، نحن «دخلنا حقبة تعتبر فيها الدبلوماسية أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، في ظلّ بيئة دولية شديدة التنافس… الصين تدرك ذلك وتوسّع نطاق قدراتها الدبلوماسية بسرعة. على النقيض من ذلك تبدو الولايات المتحدة عازمة على التخلي عن السلاح الدبلوماسي من جانب واحد».
وأضاف الكاتب: «كما أشرت من قبل، فإنّ أيّ أمل في تحقيق التوازن في مواجهة الصين في آسيا يتطلب من الولايات المتحدة الحفاظ على روابط قوية مع تحالف صعب المراس من الدول الآسيوية، وهذا يتطلب دبلوماسية واسعة المعرفة ومتطورة وصبورة ومتفانية، على الأقلّ بقدر احتياجها إلى وجود قوات عسكرية ذات مصداقية»
دول عميلة تجرّ ترامب للحرب مع إيران
أخيراً بدلاً عن القيام بفكّ ارتباط محسوب وتدريجي من الشرق الأوسط، والعودة إلى نهج توازن القوى الذي استخدمته الولايات المتحدة بنجاح منذ الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة، سمح ترامب للدول العميلة المحلية والمانحين الأثرياء والمستشارين الصقور بجرِّه مرة أخرى إلى مواجهة لا جدوى منها مع إيران. ولا يمكن للمرء أن يتخيّل سوى الابتسامات التي ترتسم على وجوه دهاقنة السياسة الخارجية في بكين، وهم يشاهدون الولايات المتحدة تتعثر باتجاه مستنقع آخر من صنعها، ويقولون في أنفسهم: كنا نعرف أنّ ذلك سيحدث.
باختصار على الرغم من إدراك أنّ تحدّي الصين كان العنصر الأكثر أهمية في أجندة السياسة الخارجية لأميركا – مع استثناء محتمل لتغير المناخ نفسه – إلا أنّ ترامب وشركاه اتبعوا سلسلة من السياسات التي يبدو أنها مصمَّمة خصيصاً لمنح الصين أكبر عدد ممكن من المزايا.
نهج «انعدام الإستراتيجية» ليس جديداً
بالرغم من كلّ ما سبق يقول الكاتب: إنّ «هذه ليست هي الأخبار السيئة. فعلى الرغم من أنّ إدارة ترامب ربما تكون قد نقلت نهج «انعدام الإستراتيجية» إلى مستوى جديد، إلا أنّ هذه المشكلة كانت واضحة قبل ذلك. إذ اعتقد بيل كلينتون أنّ الولايات المتحدة يمكنها توسيع حلف الناتو بالاتجاه شرقاً، واحتواء العراق وإيران في وقت واحد، وإدخال الصين في منظمة التجارة العالمية قبل الأوان، وتعزيز العولمة المفرطة مع عدم مواجهة أيّ عواقب سلبية خطيرة أبداً.
اعتقد جورج دبليو بوش أنّ إنهاء الطغيان والشرّ إلى الأبد يجب أن يكون الهدف الرئيس للسياسة الخارجية الأميركية، وظنّ أنّ الجيش الأميركي يمكن أن يحوّل الشرق الأوسط بسرعة إلى بحر من الديمقراطيات الموالية لأميركا. وكان كلينتون أكثر حظاً من بوش، ذلك أنّ العواقب السلبية لأفعاله لم تظهر إلا بعد أن ترك منصبه، لكن أياً من تصرفات الرئيسين لم تترك الولايات المتحدة في وضع عالمي أقوى.
فيما كان لدى باراك أوباما نظرة أكثر واقعية في ما يتصل بقوة الولايات المتحدة وعلق أهمية أكبر على الدبلوماسية، لكنه لم يفعل الكثير لتقليل التورّط العسكري الأميركي في الخارج ودعم بالكامل الاستخدام النشط للقوة العسكرية الأميركية. أرسل أوباما المزيد من القوات إلى أفغانستان في عام 2009، ودعم تغيير النظام في ليبيا وسورية، ووسّع عمليات القتل المستهدف للإرهابيين المشتبه بهم بالطائرات بدون طيار أو قوات العمليات الخاصة.
غير أنّ إدارته فشلت في توقع ردّ فعل روسيا على الجهود الغربية لتقريب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والناتو، وأثبت أنه عاجز عن توحيد البلاد وراء منهجه في تغيّر المناخ أو إيران. ولا ينبغي أن ننسى أنه في عامه الأخير في البيت الأبيض، أسقط الجيش الأميركي أكثر من 26 ألف قنبلة في سبع دول مختلفة.
وهنا يبرز التساؤل: «ما الذي يجري هنا؟ متى أصبحت الولايات المتحدة سيئة إلى هذا الحدّ في الاستراتيجية؟ السياسة الخارجية هي ميدان مليء بالتحدّي، تتفشى فيه أوجه انعدام اليقين، وتكون الأخطاء فيه أمراً لا مفرّ منه في بعض الأحيان. لكن عدم القدرة على التفكير بطريقة استراتيجية ليس راسخاً بشدة في الحمض النووي الأميركي» حسب ما يقول الكاتب.
واجهت إدارة ترومان تحديات هائلة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكنها نجحت في سياسة الاحتواء وخطة مارشال وحلف الناتو ومجموعة من التحالفات الثنائية في آسيا، ومجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي خدمت الولايات المتحدة وحلفاءها بشكل جيد على مدار عقود.
وبالمثل أدارت إدارة بوش الأول (1989-1993) انهيار الاتحاد السوفياتي، وإعادة التوحيد السلمي لألمانيا، وحرب الخليج الأولى ببراعة وخبرة وضبط نفس لا يُستهان بهم. لم تكن أيّ من هاتين الإدارتين مثالية، لكن تعاملهما مع الظروف المعقدة والجديدة أظهر فهماً أكيداً لما هو أكثر أهمية والقدرة على استنباط الردود التي يريدونها من كلّ من الحلفاء والخصوم على حدّ سواء. بعبارة أخرى: كانتا جيدتين على صعيد الاستراتيجية.
ومن المفارقات أنّ جزءاً من المشكلة اليوم هو الموقف المميّز للصدارة الذي تمتعت بها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة. ولأنّ الولايات المتحدة قوية وثرية وآمنة إلى حدّ كبير، فهي في الغالب معزولة عن عواقب تصرفاتها. عندما ترتكب أخطاء، يتحمّل الآخرون معظم التكاليف، ولم تواجه منافساً نظيراً قد يسارع في الاستفادة من الأخطاء.
فحرب العراق وأفغانستان تكلفت في نهاية المطاف أكثر من 6 تريليونات دولار وآلاف الجنود، لكن عدم وجود تجنيد يحدّ من بواعث القلق العامة بشأن الخسائر البشرية، فيما تدفع الولايات المتحدة تكلفة جميع هذه الحروب من خلال اقتراض الأموال من الخارج، وإدارة معدلات عجز كبيرة، وتحميل الفاتورة للأجيال المقبلة.
الأميركيون لا يهتمّون بما يحدث في الخارج
يساعد هذا الموقف في تفسير سبب اهتمام عدد قليل من الأميركيين بما يحدث في الخارج أو ما تفعله الحكومة الأميركية حيال ذلك. وفقاً لديان هيسن، التي أجرت مقابلات متعمّقة مع لجنة مكونة من 500 أميركي منذ عام 2016، «معظم الناخبين لا يهتمّون كثيراً (بالسياسة الخارجية)، وهذه مشكلة». وحين طلبت استطلاعات أخرى أحدث من الأميركيين أن يدرجوا أولوياتهم العليا في قائمة، لم تكن السياسة الخارجية حتى ضمن العشرة أولويات الأولى.
وعندما لا يستطيع معظم الأميركيين تحديد الفرق بين النجاح والفشل – على الأقلّ من حيث العواقب الفورية الملموسة – سيكون صنّاع السياسة معرّضين لضغوط أقلّ من أجل الخروج باستراتيجيات ناجحة فعلاً وسوف يتقدّم السلوك الزائف على الأداء الفعلي.
ثم هناك الغطرسة. فلطالما اعتبر الأميركيون أنفسهم نموذجاً للآخرين، وقد عزز النصر في الحرب الباردة الاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة كانت لديها الصيغة السحرية للنجاح في العالم الحديث.
علاوة على ذلك اعتقدوا أيضاً أنّ الجميع تقريباً من جميع أنحاء العالم أدركوا هذا، ولا يمكنهم الانتظار لمتابعة تقدّمهم والانضمام إلى نظام عالمي تقوده الولايات المتحدة، وتصبح مثلهم تدريجياً. واقتناعاً منهم بأنّ الرياح التاريخية تأتي بما يشتهونه، يعتقد قادة الولايات المتحدة أنّ طريقهم مفروش بالورود. فمن الذي يحتاج إلى استراتيجية متماسكة ومعقدة ومصممة بعناية عندما تكون الاتجاهات العالمية القوية تدفع العالم بالفعل في الاتجاه الذي يريدونه؟
لماذا تسيء أميركا فهم العالم؟
علاوة على ذلك، كما يشرح بول بيلار في كتابه المهمّ «لماذا تسيء أميركا فهم العالم» Why America Misunderstands the World، فإنّ التجربة التاريخية غير العادية للولايات المتحدة، والعزلة الجغرافية، والسوق المحلية الكبيرة، والجهل العام؛ أضعفت قدرتها على صياغة استراتيجيات سياسة خارجية قابلة للاستمرار.
يتطلب وضع استراتيجية فعّالة للسياسة الخارجية توقع كيفية ردّ فعل الآخرين، لكن المسؤولين الحكوميين – ناهيك عن الجمهور بشكل عام – لا يعرفون سوى القليل عن البلدان التي يحاولون التأثير على أفعالها.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأسطورة الدائمة لـ «بوتقة الانصهار» – والتي تصوّر المهاجرين إلى الولايات المتحدة على أنهم يعتنقون بسهولة الهوية الأميركية الجديدة ويندمجون بسلاسة في نسيج المجتمع الأميركي – تقود البلاد إلى التقليل من قوة القومية والعرق ومصادر أخرى دائمة للهوية المحلية، الأمر الذي يؤدّي بدوره إلى التقليل من شأن صعوبة بناء الدولة أو الأمة في المجتمعات المتنوعة.و
بسبب يقينها باستقامتها ونواياها الطيبة، تعدّ الولايات المتحدة بطيئة في إدراك أنّ المجتمعات الأخرى قد يكون لديها أسباب وجيهة للتشكيك في دوافعها أو اعتبارها خطيرة. وتشكل هذه النقاط المحجوبة مجتمعة عقبة خطيرة أمام تطوير استراتيجية فعّالة للسياسة الخارجية، وخاصة تجاه أجزاء من العالم تختلف تجاربها التاريخية وعناصرها الثقافية اختلافاً جذرياً عن تجارب الولايات المتحدة.
ويؤكد الكاتب أن ّالسمات الرئيسة للنظام الديمقراطي الأميركي تجعل من الصعب وضع سياسة خارجية وسياسة أمن قومي متماسكة وتنفيذها، خاصةً عندما لا يكون هناك خطر واضح وحاضر لتركيز العقل وفرض الانضباط على مناقشات السياسة الخارجية. فعندما يكون معظم الجمهور غير مبال، تستحوذ جماعات الضغط المحلية والأجنبية على عملية السياسة بسهولة، خاصة في عصر يلعب فيه المال دوراً رئيساً في السياسة.
وبدلاً عن سوق حقيقي للأفكار، تناقش فيه الوصفات السياسية المتنافسة بعناية وبأمانة، تصبح السياسة الخارجية ساحة تهيمن عليها أعلى الأصوات وأكثرها تمويلاً أو تفضيلات مجموعة صغيرة من المانحين الأثرياء. ويلفت الكاتب إلى أنّ الولايات المتحدة ربما تكون عرضة للنفوذ الأجنبي أكثر من أيّ قوة عظمى في التاريخ الحديث.
وإذا حصلت مجموعة من هذه الجماعات ذات المصالح الخاصة على الأقلّ على بعض ما تريده (على سبيل المثال ميزانية دفاع أكبر أو مزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان أو رفض اتفاقيات تغيّر المناخ أو دعم غير مشروط لبعض الدول العميلة إلخ…) سوف تتآكل القدرة على تطوير استراتيجية شاملة لفائدة الأمة ككلّ. وفي أفضل الأحوال، ينتهي الأمر بالولايات المتحدة وهي مثقلة بالالتزامات. وفي أسوأ الأحوال، ينتهي الأمر باتباع سياسات متناقضة بشكل متبادل، وبالتالي انهزامية.
المجتهدون يهمَّشون والفاشلون يجرى تصعيدهم
يتابع الكاتب: «من الناحية المثالية سوف تتعلم المؤسسات المسؤولة عن وضع السياسة الخارجية وإدارتها أيضاً من التجربة بمرور الوقت. ولكن كما أوضحت باستفاضة في أماكن أخرى، هناك القليل من المساءلة في مؤسسة السياسة الخارجية اليوم».
لا تزال الأفكار السيئة قائمة بغضّ النظر عن عدد مرات ثبات بطلانها، والأشخاص الذين يخطئون في الأمور مراراً وتكراراً يجري تصعيدهم على نحوٍ روتيني بالرغم من الفشل، بينما يجري تهميش الأشخاص الذين يقومون بالأمور بالشكل الصحيح. ويلفت المقال إلى أنّ الأفراد و/ أو المجموعات الذين تصوّروا وسوّقوا وأفسدوا حرب العراق يظلون من بين الشخصيات المحترمة اليوم، وبعضهم يعتبر مؤهّلاً للخدمة في المستقبل.
يدعو الكاتب إلى النظر إلى صفحات الرأي والافتتاحيات في صحف «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» وستجدها زادت فعلياً من عدد كتاب الأعمدة المنتظمين الذين أيدوا تلك الحرب، لكنها لم تقدّم كاتباً توقع بشكل صحيح أنها ستكون كارثة. فإذا كان أولئك الذين يضعون استراتيجيات سيئة لا يدفعون أيّ ثمن، وأولئك الذين يقترحون بدائل أفضل لا يلقون أيّ اعتراف بهم، فلماذا ينبغي لأيّ شخص أن يتوقع أن تبلي البلاد بلاء حسناً؟
الرؤساء يكذبون للحفاظ على شعبيتهم أو كسب التأييد لسياساتهم
وأردف الكاتب: «يميل المرء إلى رؤية هذه الإخفاقات العديدة على أنها نتيجة حتمية للتحوّل التدريجي لأميركا من جمهورية إلى إمبراطورية عالمية، دولة قوية لا تستطيع التوقف عن التدخل في جميع أنحاء العالم. وسبق أن حذر الآباء المؤسسون من أنّ أيّ جمهورية لا يمكنها الدخول في حرب مستمرّة بصورة أو بأخرى دون أن تتعرّض للفساد، وكانوا على صواب».
هذا ما فهمه الجنرال ذو النجوم الخمس، الرئيس السابق دوايت آيزنهاور. إنّ شنّ الحرب باستمرار يتطلب مؤسسات قوية للأمن القومي ومزيد من السرية الحكومية والتوسع التدريجي للسلطة التنفيذية. وتتلاشى الكوابح والتوازنات، ويجرى التغاضي عن انتهاكات القانونين المحلي والدولي، ويصبح الإعلام مجنّداً ومتواطئاً، ويجرى إسكات المنشقين أو تهميشهم، ويجد الرؤساء وأتباعهم أنه من الأسهل على نحو متزايد أن يكذبوا للحفاظ على شعبيتهم أو كسب التأييد للسياسات التي يفضلونها.
وبمجرد أن يتدنّى الخطاب العام وينفصل عن العالم الواقعي، يصبح الخروج باستراتيجيات ستنجح فعلياً في هذا العالم عملاً أشبه بالمستحيلات.
في الختام يقول الكاتب: «كما قلت في العمود المشار إليه سابقاً، نحن وصلنا إلى نقطة تكون فيها السياسة الخارجية وسياسة الأمن القومي في الولايات المتحدة أشبه كثيراً بفنّ الأداء. ولا تعتبر نتائج الإجراءات الأميركية مهمة حقاً، باستثناء في ما يخصّ الجنود والبحارة وطواقم الطائرات والدبلوماسيين الذين تكلفهم بتنفيذ هذه السياسة.
الشيء الوحيد الذي يهتمّ به قادة الولايات المتحدة هو كيف يعرض ذلك على التلفزيون أو على «تويتر» أو بين جمهور الناخبين الذين يهتمّون بالترفيه عن أنفسهم أكثر من البحث عن تنويرهم أو قيادتهم بكفاءة. ولأنّ الولايات المتحدة لا تزال قوية وآمنة إلى حدّ كبير، فمن المحتمل أن تستمرّ في هذا الطريق لبعض الوقت. لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلى الأبد، وستواصل إضاعة الفرص التي تجعلها أكثر أماناً وازدهاراً، وتساعدها على بناء مجتمع يرقى إلى مستوى مُثُلها النبيلة».
«ساسة بوست»